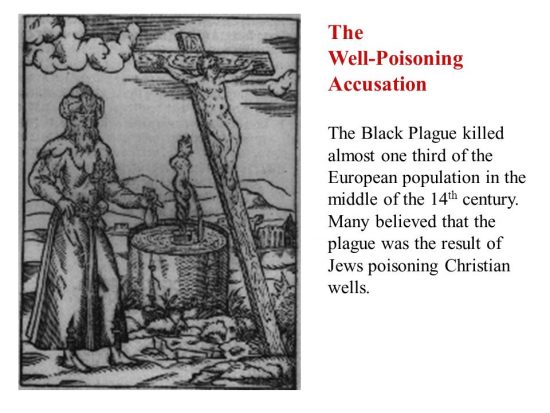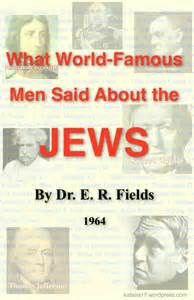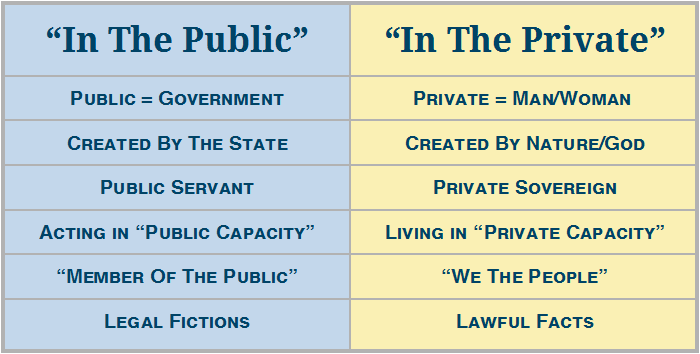بقلم منذر هنداوي
ماذا تشعر عندما تقرأ هذ العبارة؟: “يجب وضع قانون لا يُسمح فيه للطفل المشوه بأن يعيش”. أظن أن الغالبية العظمى من الناس ترفضها. لكن ما هو موقفك عندما تعرف أن من كتبها هو الفيلسوف أرسطو؟!
قرأت هذه العبارة بدراسة موضوعها: (تطور نظرة المجتمعات تاريخياً للمعوقين). لم أصدق في البداية أنها لأرسطو. رجعت لعدة مراجع على النت، و تأكدت من صحة الاقتباس. لا بل وجدت أكثر من هذا. فهذا الرأي لم يكن حالة استثنائية بل منتشراً و مقبولاً. ف أفلاطون يرى: “أنه يجب توفير العلاج للمواطنين الذين أحوال صحتهم العامة جيدة. أما الآخرون الذين صحتهم العامة متدهورة، فمن الأفضل أن يتركوا يموتون… كذلك يجب الحكم بالموت على أولئك الذين صحتهم النفسية غير قابلة للعلاج”. و في قوانين أثينا في القرن الثالث قبل الميلاد نصٌ يبرر قتل الطفل خلال سبعة أيام الأولى من الولادة إذا ظهرت عليه مظاهر الإعاقة: “المولود الجديد لا يعتبر طفلاً إلا بعد سبعة أيام من الولادة، فإذا وضحت عليه بعض ملامح الإعاقة يتم التخلص منه بدون تأنيب الضمير لأنه ليس طفلاً بعد. أما الطفل الجيد الذي يحتفظ به فيجب ان يكون وسيماً و غير مشوه او معاق. غير ذلك فهو سيّء يتوجب التخلص منه”.
هناك أمور مروعة أكثر في تلك الحقبة كحقوق العبيد و حقوق المرأة التي تصل لدرجة ان القانون يسمح بقتل المرأة إن أنجبت بعد سن الأربعين. اكتفي بهذا و لمن يهتم بالتوسع فهذا احد الروابط على النت.
أجزم لو ان شخصا في هذا العصر تكلم بهذا الشكل لقامت الدنيا عليه، و حاربته منظمات حقوق الانسان. الرئيس الامريكي ترامب قّلد حركات أحد المعاقين فقامت الصحافة عليه و انتقده معظم أصحاب الرأي. في اوربا قد يضطر المسؤول للاستقالة اذا ثبتت عليه بعض المواقف العنصرية ضد المرأة أو ضد السود أو المعوقين. لكن هذا الذي بات غير مقبولا اطلاقاً في عصرنا كان مقبولا في فكر أكبر فلاسفة العالم القديم و في قوانين أقدم ديمقراطية بناها الإنسان. مما لا شك فيه أنه كان يوجد معارضين وقتها لاستعباد الناس و الاعتداء على حق المعاقين في الحياة، لكن من الواضح أن الرأي السائد كان يجيز ذلك و يبرره.
أعود للسؤال كيف أحكم على هذين الفيلسوفين أو على ديموقراطية أثينا؟ هل أحكم بمعايير العصر الراهن و أُجرم فلاسفة ذلك العصر و أعتبرهم بلا إنسانية و أحرق كتبهم؟ أعتقد أنه لا يحق لي أن أبني مثل هذ الحكم. و أظن أنه لا يوجد مفكر يستطيع التنكر لدور مثل هؤلاء الفلاسفة في بناء الفكر و تعليم التفكير و المنطق. الباحثون القائمون على هذه الدراسات لا يدرسون بقصد الإدانة، إنما بقصد فهم الظروف التي أدت إلى نشوء تلك النظرة لفلاسفة كبار بحق المعوقين. يدققون في الأدلة و ما إذا كان الهدف من التخلص من المعاقين و المرضى نفسياً كان بسبب ما يعرف الآن “بالموت الرحيم” الذي تسمح به بعض الدول لتجنيب المريض آلاماً حادة و هو في حالة ميؤوسة منها للحياة. أو يدرسون ما إذا كان السبب يعود إلى تحسين النسل في المجتمع ككل رغم ما يحمله هذا من عذابات للأفراد. و في الخلاصة يتوصل الباحثون طلاب العلم الى نتائج مفيدة في فهم تطور الفكر البشري و تطور النظرة الإنسانية للمجتمعات، لكن لا تجد اطلاقاً في كل تلك الدراسات الحديثة عن ذلك الماضي القديم كلمة “إدانة”.لسوء الحظ في بلادنا كثير منا من يبدأ بالإدانة، و أخذ المواقف، و القفز بسرعة لإثبات أو دحض هذه الفكرة أو تلك بقليل من التفحص و الأدلة.
إذاً لماذا لا يدين الباحثون هذين الفيلسوفين بينما يدينون من يتبنى رأيهما في عصرنا الراهن؟ الجواب بسيط؛ لكل عصر قيمه و مفاهيمه و وسائل الحكم عليه. لا نستطيع أن نحكم على قيم مجتمع قبل ٢٤٠٠ سنة بمعايير قيم مجتمعنا المعاصر. فهل نستطيع أن ندين مثلا فرعون على العبودية. قبل عدة آلاف سنة كانت العبودية تتوسع و تترسخ. كانت حالة إجتماعية أرقى من حياة الناس في الغابة و البراري. العبيد صاروا أساس نظام انتاج في كثير من أجزاء العالم. صاروا افضل حالاً بكثير من أناس الغابة الذين لا يعرف المرء منهم ان كان سيجد طعاماً ليومه أو سيقتل بغارة محتملة في آي وقت. في اثينا صار العبيد أكثر أمناً و تغذية و انتاجاً. و هذا التطور في استخدام العبيد في الانتاج هو ما ساهم بتقسيم العمل الى عمل عضلي بدني و عمل فكري. طبقة العبيد تعمل بيديها. تنتج و تقدم الخدمات. طبقة السادة تعمل بذهنها. تفكر و تخطط و تقود و تشرف. هذا التقسيم سمح لأصحاب الامكانات الذهنية أن تتفرغ اكثر للعمل الفكري. فتطورت اللغات و الرياضيات و الهندسة و الفلسفة. لولا العبودية لما تطورت الحضارة الفرعونية و لما ظهرت بابل و لا انتعشت الفلسفة اليونانية، و لا تألقت ديموقراطية أثينا.
في هذا السياق لا يحق لنا تحقير فرعون و لا فلاسفة اليونان بحجة تقبلهم لنظام العبودية. نفس الأمر يمكن أن ينطبق على نظرتهم للمعوقين و الذين يعانون نفسياً. و مهمة الباحثين تقديم تفسيرات مفصلة تشرح سبب هذه النظرة التي كانت مقبولة قبل عدة الاف سنة و صارت مرفوضة في عصرنا الراهن. أما من يريد ان يقذف و يرمي و يتهم دون ان يحاول ان يفهم و يفسر فهو خارج موضوع البحث و التقصي و المعرفة. إنه ينتمي الى مجموعات الهوبرة و المسخرة مهما تستر بعباءة الغيرة على حقوق الإنسان.
نفس الأمر يمكن اسقاطه على من يبحثون في الأديان عن عيوب كي يتهموها بالتخلف و القصور. هناك مثلاً من يسخرون من الإسلام لعدم وجود ديموقراطية فيه، و هناك بالمقابل من يجهدون أنفسهم لشرح الآية “و أمرهم شورى بينهم” على أنها دليل على الديموقراطية في الإسلام. لا الهجوم على الإسلام بحجة عدم وجود ديموقراطية فيه صحيح، و لا التأكيد على وجود ديموقراطية في الاسلام صحيح. أنظمة الحكم التي كانت سائدة في كل الدول المحيطة في عهد صعود الاسلام لم تكن مبنية على أسس ديموقراطية. جميعها ملكيات وراثية. لم تكن فكرة الانتخابات و البرلمانات موجودة. لم تتوصل الانسانية لها بعد. و لم تكن مهمة الاسلام أو أي دين اختراع الديموقراطية في ذلك العصر.
الهجوم على الاسلام من جوانب أخرى كتعدد الزوجات و الجواري و عدم تحريم السبي لا يختلف بجوهره عن الهجوم على فلسفة أرسطو و أفلاطون و ديموقراطية اثينا بسبب نظرتهم تجاه المعاقين أو العبيد. إنه حكم بمعايير عصر على عصر آخر مختلف كلياً. السبي و العبيد و الجواري كان من طبائع معظم الشعوب و الحروب في ذلك الوقت. الاسلام لم يغير كثيرا فيما كان موجوداً. دعى الى وحدانية الخالق. جعل العبادة لله وحده عوضاً عن عبادة الأفراد او الاصنام. لم يلغ العبودية و ان حث على عتق العبيد. حرم وأد البنات. بين المحظورات و المسموحات. لكن تبقى الرسالة الكبرى في كل تعاليم الاسلام: الاخلاق، و هو ما عبر الحديث النبوي: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”. لو لم تكن تلك الاخلاق جوهر رسالة الدين لما انتشر الاسلام بين ملايين الناس. لا يمكن لدين أو لفكر ان يبقى حياً عبر مئات السنين ما لم يكن فيه مقومات انسانية تريح النفس و الوجدان. كل الأديان السماوية و غير السماوية تتشارك بقيم عليا تلامس عقول الناس و تواسي آلامهم و تعدهم بالإنصاف و تريح نفوسهم .
من يريد اعادة انتاج السبي كما تفعل داعش لم يفهم قط الرسالة السامية للدين و لا دور الدين في تطوير الاخلاق و ترويض جوامح التوحش في الانسان. من يريد اعادة السبي باسم الدين إنما هو عدو الدين و عدو المنطق و عدو الانسانية. بالمقابل فإن من لا ينفكون يهزؤون من الدين بالعودة الى نصوص تجيز السبي و العبودية لا يختلفون بمنطقهم عمن يدافعون عن السبي و العبودية. كلا الطرفين لا يدركان معنى التطور و لا معنى الرسالة. لا يميزان بين ما هو جوهري و ما فرعي او ثانوي. يقرؤون الكلمات في القرآن الكريم بعيداً عن سياق معناها، و عن مبرراتها في ذلك العصر المختلف عن عن عصرنا.
داعش، و أعداء داعش الذين يصورون أن الاسلام أنه داعش، في صف واحد. فكلاهما لا يميزان بين الأساس و بين الفرع. بين الروح و بين الجسد. يتمسكون بالفرع و كأنه الأصل. داعش أخذت بالسبي و نسيت مكارم الاخلاق. أعداء داعش لا يريدون ان يَرَوْن في الإسلام غير السبي و ما شابه. يغوصون بكل التفاصيل التي يمكن أن تسيء للإسلام و لا يتذكرون أن الرسالة الكبرى للاسلام هي في الأخلاق، و في تطوير قيم الخير في الانسان. جرِّد الاسلام من هذه القيم فماذا سيبقى منه؟. جرد الفكر و الأدب و الفلسفة من رسالة إنسانية كبرى فعلى ماذا ستحصل؟ جرد الكلمات من معانيها و من سياقاتها فعلى ماذا ستحصل؟. ستحصل على أصنام و على عبدة اصنام. داعش و نظراؤها ممن اختطف رايات الحسين يريدون ان يعيدونا إلى عالم الاصنام. إلى تحجر الفكر و الكلمات.
لكن الفكر ليس صنما. الفكر نهر يتجدد بالمعاني. الكلمات ليست أحجارا نتراشق بها، بل هي ثمرات تغذي الروح و العقل كي تزهر عقول الناس من جديد معان و قيم و أفكار و صور جديدة. عندما نغني الكلمات بمعان جيدة و الوان جميلة نستطيع أن نرى الواقع الحي بمنظار أفضل. من يحبس الكلمات بمعان ثابتة و يعيد تكرارها و ترديدها دون فهم لحاجة التجديد في مضامينها إنما يحنطها لتصبح كالمومياء؛ شكلٌ متجلد لكائن (كان) فيه روح، و (صار) شكل كائن بدون روح.
روح الانسان و سره في السعي نحو الفهم و التعلم و الاجتهاد في كيفية تحسين حياة الناس في مجتمع متطور متآخ متعاضد. ذلك ما حاول أفلاطون أن يفعله في جمهوريته أو مدينته الفاضلة. و اجزم لو ان افلاطون عاش في هذا العصر لكان هو و تلميذة أرسطو أول من يسعى لاجتثاث العبودية، و أكثر من يناصر تحسين الرعاية الصحية و الاجتماعية للناس و رعاية المعوقين. و بنفس القدر لو ظهر رسول الاسلام من جديد لكان أول من تبرأ من أفعال داعش و من سارقي رايات الحسين.
Related posts:
Views: 0
 RSS Feed
RSS Feed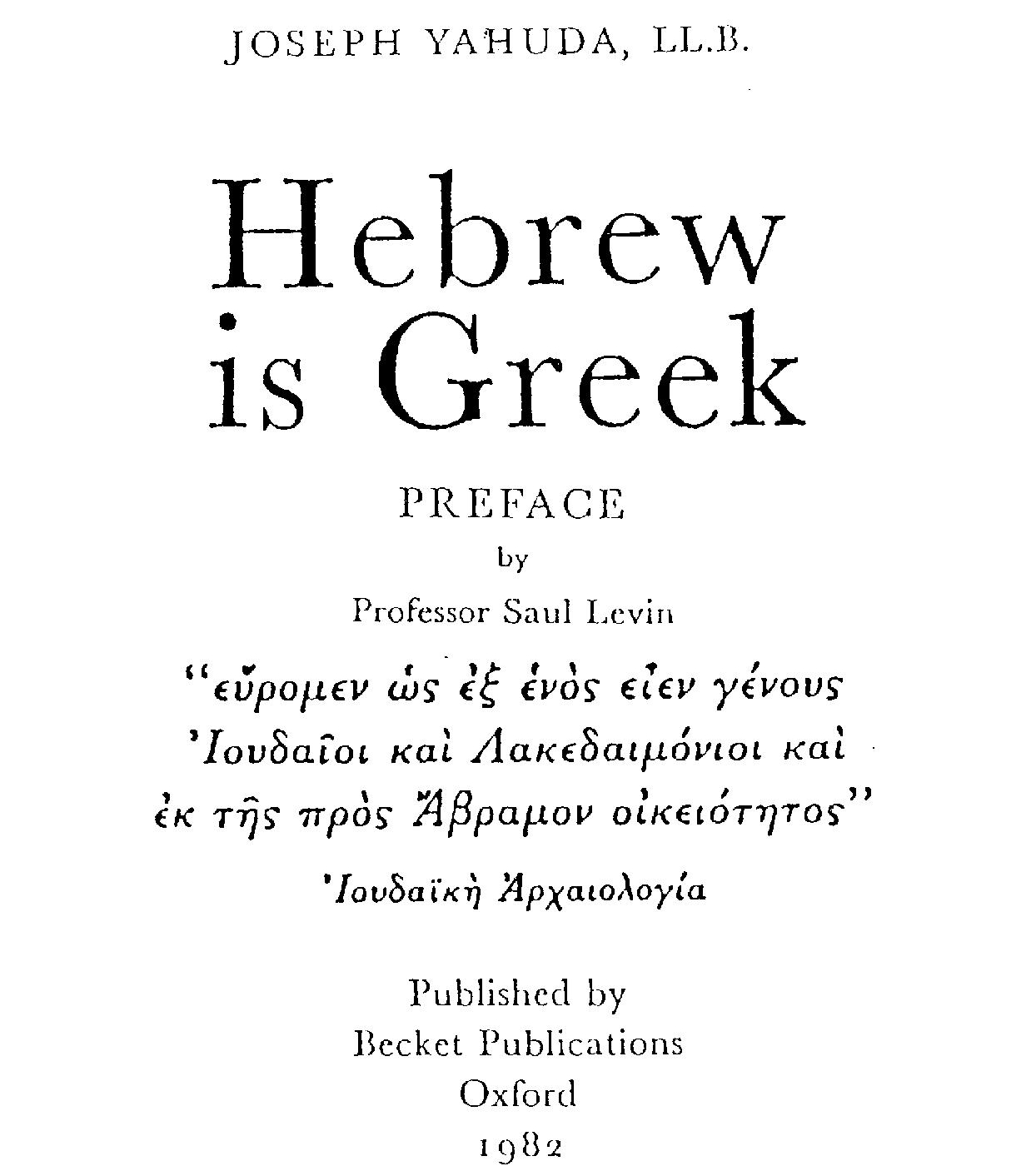
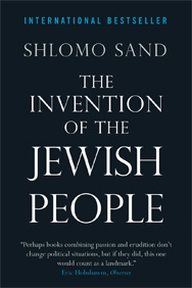


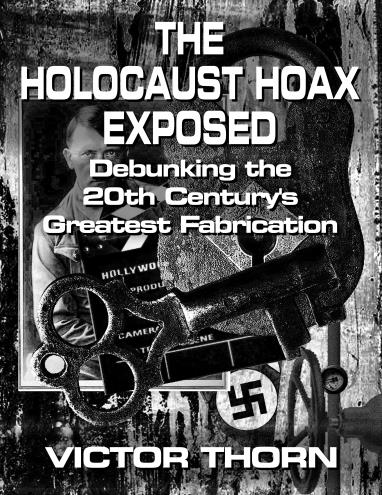
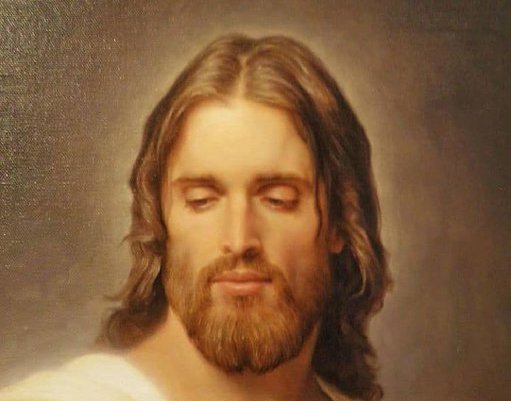

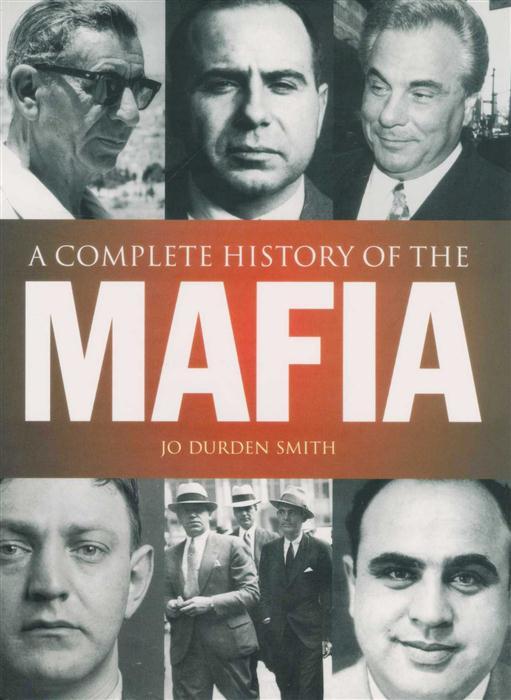










 May 21st, 2017
May 21st, 2017  Awake Goy
Awake Goy 
 Posted in
Posted in  Tags:
Tags: